جسر: متابعات:
في الصفحات الأخيرة من الفصل المركزي الذي يعقده سفير فرنسا السابق في سوريا (2006-2009)، ميشال ديكلو، “الحرب الأهلية السورية الشاملة” (على معنى المعولمة)، يتناول حال هذه الحرب في الوقت الذي ينهي فيه كتابه (الليل السوري الطويل، دار الأوبسرفاتوار، باريس، حزيران/يونيو 2019). فيكتب ما موجزه: إنها حرب لا تريد وضع أوزارها، فتركيا في الشمال، وإيران ومستشاروها وميليشياتها العسكرية وقواعدها في أنحاء سوريا كلها، و”حزب الله” القوة الأهلية المسلحة البارزة، منخرط في ميادين القتال، وروسيا تسيطر على قاعدة حميميم الجوية وتنشر مرتزقة وقوة شرطة عسكرية في مواقع كثيرة، واسرائيل تقصف “حزب الله” وإيران فوق المئة مرة منذ 2011، والولايات المتحدة تأمر قواتها الخاصة بالانسحاب وتدعم الأكراد في الشمال الشرقي ويتوقع ألا تتخلى عن القيام بدور في الحوادث الجارية والآتية.
ويتناول الكاتب الأحوال في إدلب، ملجأ البقية الباقية من المنظمات والفصائل المقاتلة والمتناحرة كلها، وخزان اللاجئين مما يسمى من غير سخرية ولا إدراك “مناطق المصالحات والتسويات”، وهي مناطق التهجير والجمر تحت الرماد والثارات المستأنفة. فينبه إلى الصدامات الخطرة التي قد تقدم عليها تركيا ودمشق. فمبادرة النظام إلى مهاجمة إدلب، وليس جوارها القريب إلى الشمال من حماة على ما حصل في الأسبوع الثالث في آب (أغسطس) الجاري، تترتب عليها ذيول إنسانية لا يسع تركيا القبول بها أو تحملها، فترد بمقاومة الهجوم الحكومي (الرئاسي)، والهجوم الحكومي عسير أو ممتنع بغير “غطاء” روسي.
فماذا يُتوقع أن تصنع روسيا؟ ومنذ كتابة ديكلو صفحاته هذه (131-133) جدَّ “حصار” بلدة مورك، أي نقطة المراقبة التركية التاسعة (من 12) بضاحية خان شيخون، وأعرب الرئيس التركي عن حمله التقدم السوري المشفوع بـ”النصر” الروسي على “تهديد الأمن القومي” التركي ووازنت الصحافة الروسية بين ثمرات الشراكة الروسية –التركية (في ميادين خطوط النفط والتسليح والمبادلات التجارية) وبين المكاسب العسكرية والاستراتيجية في سوريا إذا اضطرت روسيا بوتين ولافروف إلى التخلي عن شق من الاثنين. والحرج الروسي احتاج إلى لقاء “قمة” أولي وعاجل في موسكو، وثانٍ منتظر بين أطراف سوتشي الثلاثة في أواسط الشهر القادم، وتبرع القوات الروسية بحماية النقطة التركية التاسعة. وتناولُ ديكلو المسألة على هذا القدر من الدقة من الأدلة الكثيرة على تنبهه إلى تعقيد الحوادث والأوضاع، وعلى احتمال أطوارها القادمة وجوهاً ومعاني تتستر عليها التقارير المستعجلة.
جدل الراديكالية والعصبيات
وحين يروي السفير السابق بدايات الحركة السورية، وتشخيصه دلالاتها يومذاك، يوجز رأيه بجملة ما لاحظه وعاينه في أثناء السنوات الاربع التي قضاها، على ما يقال، ذارعاً البلد طولاً وعرضاً، وممهداً الطريق إلى إنفاذ المهمة الديبلوماسية التي أوكلها إليه الرئيس جاك شيراك: الانتقال من معاداة “القتلة والمجرمين” الذي يحكمون سوريا (واغتيال رفيق الحريري والاغتيالات اللاحقة إلى 2007 آخر مآثرهم) والقطيعة منهم إلى محاولة وصل بعض ما انقطع في انتظار أحوال أكثر مؤاتاة من الأحوال القاسية القائمة والمتاحة. وتقوده مقارنته الانزلاق السوري الى الجحيم الذي عرفه السوريون بوقوف تونس ومصر وليبيا على شفير الهاوية، إلى إبراز عاملين: “راديكالية” القمع الاستخباري الرئاسي والحكومي، من وجه، وبنية السكان “العثمانية” (المذهبية الملية) والمختلطة، من وجه آخر.
فدوائر السلطات الثلاث: “العائلة”، و”المخابرات ورجال الأعمال”، و”أهل الدولة” الظاهرة و”موظفوها”، تُجمع، على تفاوت في الحصص والعوائد، على أن “سوريا” هي مادة أصحاب هذه الدوائر وملك يمينها، وأن السوريين هم صنيعتهم أي “صناعهم” على معنى خدامهم. ومن هذا يقينه واعتقاده، إلى سبق معاناته الإقصاء والازدراء المذهبيين والاجتماعيين قروناً، لا يلين للمفاوضة، ولا يرى في طلب الحقوق والمساواة واحترام الكرامة إلا شق عصا الطاعة والتمرد وشهوة الاقتسام والثأر. أما الوجه السكاني “العثماني”، الملي، فيُحكّم العصبيات الحادة والمتنافرة في حساب الخسارة والربح السياسيين. فيقاس الموقف أولاً في ميزان الضرر الذي يلحقه في الخصم أو المنافس أو “العدو”، في آخر المطاف. وذلك قبل قياسه أو وزنه في ميزان الربح الذي يعود به على العصبية وأهلها. ويتذكر الواحد الجهد الذي استفرغه “رؤساء” الهيئات الوطنية السورية في نفي “الطائفية” عن النزاع السوري، وإضافة الصفة إلى “السلطة العلوية” وحدها، وإلى المنظار “اللبناني” وربما “الاستشراقي” الذي يغلب على التشخيص هذا. فينتبه ربما، متأخراً، إلى جدل راديكالية الحكم وثورة العصبيات (الاسلاموية والمذهبية والقومية الاتنية والمحلية).
إحجام أميركي وإقبال روسي
ويلاحظ ديكلو، وهو يصف علاقات أقطاب النزاعات على مثال زوجين (عنف السلطة العلوية- ثورة العصبيات المتطرفة)، افتقار التدخل الخارجي، الأميركي والروسي “على الخصوص”، إلى التكافؤ والتناظر. فبينما يحجم الرئيس الاميركي عن التدخل العسكري في آب (أغسطس) 2013، حين يدعو استعمال النظام غاز السارين في الغوطة الشرقية إلى ردع تقره قوانين الشرطة والعلاقات الدولية، تنخرط السياسة الروسية في أيلول 2015 في دعم النظام الكيماوي من غير تحفظ، بذريعة التصدي “للجهاديين” ونصب عينيها هدف وحيد هو حماية الأسد ونظامه، وتجديد سلطته على سوريا. وعلى هذا، تدور المرحلة الأولى من الحوادث والوقائع، بين 2011 و2013، على الامتناع الأميركي. وتدور الثانية، بين 2015 و2017-2018، على الانخراط الروسي. ويفترض تأريخ الكاتب مرحلتين أخريين مختلطتين: 2013-2015، و2018-2019.
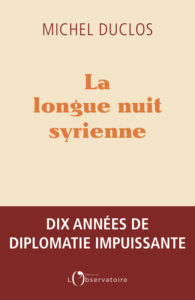
ونشأ الجيش السوري الحر في 2012 مع خسارة النظام معظم الأراضي الاقليمية السوري، في الداخل وعلى الأطراف (النفطية). وصحبت المجالس المحلية (“التنسيقيات”) هذه النشأة، وتولت إدارة كادت أن تكون دائرتها “وطنية”. وأظهر النظام، نظير توسع الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة وعسر توحيد القوات المنشقة، تماسكاً سانده “عرابوه” الروس والإيرانيون من غير تردد. وتوسل النظام إلى تحطيم شبكة التواصل الاجتماعي التي ربطت بين الناشطين المتعلمين، وطليعة الحركة الديموقراطية، بتقنيات الحرب السيبرانية التي طورها الروس والإيرانيون، ونقلوها إلى “المخابرات” المحلية. وأعملت “المخابرات” التقنيات هذه في اعتقال الناشطين واغتيالهم. وبين حزيران (يونيو) وتشرين الأول (أوكتوبر) 2011 حرر النظام من معتقل صيدنايا أمثال زهران علوش وأحمد عيسى وحسان عبود، من الإسلاميين، وحَملَهم ضمناً وصراحة على تحقيق دعواه في “طبيعة” الحرب الدائرة التي أرادها حرباً بين الجماعات “الجهادية” الارهابية وبين حكم “علماني” عروبي.
وبادرت الأمم المتحدة، وفي ركابها الجامعة العربية، في شتاء العام 2012 وربيعه، إلى اقتراح خطة سلام من 6 بنود، أُقرت في آذار (مارس) ونَشرت مراقبين دوليين على الجبهات. وأراد الأسد إيهام “المجتمع الدولي” برغبته في المهادنة والتعاون، بينما كذب قصف حمص وحماة، في أوائل نيسان (أبريل) 2012، حقيقة هذه الرغبة. واختبر النظام، في تشرين الأول (أوكتوبر) 2011 وفي تموز (يوليو) 2013، ثبات وقوف موسكو وراءه في مجلس الأمن، واطمأن إلى تضامنها ورعايتها سياسته وقمعه منذ خطوات المعارضة الأولى. ويكتب السفير السابق والمراقب الدائم أنه خلص من هذه الوقائع، منذ ربيع 2012، إلى أن السبيل الوحيد إلى ردع الأسد وفريقه، وتقييد جموحه إلى أقاصي العنف الأهلي، هو المبادرة الغربية إلى قصف مرافق قيادة النظام وتدمير مراكزها ورؤوسها، من غير تبني هذه العمليات. واستبق الإحجام عن هذا الصنف من عمليات الردع الرجوعَ عن الرد على السلاح الكيماوي.
وفي صيف 2012، عمدت قوات النظام إلى قصف مناطق المعارضة بحلب وأطراف دمشق قصفاً عنيفاً ومتصلاً. وحولت “المناطق المحررة” إلى مناطق دمار، وأوقعت عدداً هائلاً من القتلى، وأوهنت معنويات السكان. واقترح الأتراك إذ ذاك إنشاء “مناطق آمنة” و”حظر طيران”. فتعللت هيئات الأركان الأطلسية بضخامة الأعباء المترتبة على المهمة، وتذرعت بذلك إلى التنصل منها. ولم يرضَ الحلفاء الغربيون أصلاً نقل سلاح أرض – جو المضاد للطيران إلى المعارضة خشية استيلاء جماعات إرهابية مناوئة عليه.
“روح” الحرب الجديدة
ويؤرخ الكاتب المراقب الانعطاف الذي أدى الى ختام المرحلة الأولى بواقعتين متزامنتين ومتصلتين: الاستيلاء على القصير وتهجير أهلها في أيار (مايو) 2013 وقضية السلاح الكيماوي في آب – أيلول من العام نفسه. فانخراط “حزب الله”، منذ 2012، كان القرينة البارزة على الاستقطاب الطائفي والمذهبي وغلبته على النزاع الأهلي. وآذن بتقوية صدى المقالات “الجهادية” السنية، الهامشية إلى يومها، في صفوف السوريين. وعوَّض الأسد نقص المقاتلين في قيادته وعصبيته بإلقاء المواد السامة على شرق غوطة دمشق. وربما أراد، على ما يتكهن الكاتب، اختبار الغربيين وفي مقدمهم الرئيس الأميركي أوباما الذي صرَّح بأن القتل بالمواد السامة “خط أحمر” يستدعي الرد الرادع. واقترحت الديبلوماسية الروسية مخرجاً “لامعاً”. فرضخ الحكم السوري لتدمير أسلحته الكيماوية المخزونة، وهو كان ينكر قبل يوم واحد حيازته مثل هذه الأسلحة.
ويقر ديكلو لأوباما بقوة حجة راجحة واحدة احتج بها دفاعاً عن امتناعه من القصف، وهي التالية: ليس في مستطاع أعمال قصف متفرقة تغيير مجرى الحرب الدائرة، وصمود النظام كان ليلوح به دليلاً على عظمة مقاومته. وعلى هذا، فالرد المجدي على السلاح الكيماوي يفترض إطاراً يلزم الدول الغربية والولايات المتحدة بسلسلة عمليات عسكرية لاحقة قد تؤدي إلى تورط لا يعلم أحد احتمالات تطوره. وكان أوباما يسعى في إخراج السياسة الأميركية من “ورطاتها”. ويُلمح الكاتب إلى أن اتفاق القصف الكيماوي الأسدي مع الانخراط الغربي في مفاوضة إيران على اتفاق يلجم خططها النووية، وحرص أوباما على نجاح هذه المفاوضة، ربما تضافرا على تقييد السياسة الأميركية. وحجة إدارة أوباما الثانية: ترتب حشد عشرات الآلاف من الجنود على القرار بالتدحل، تبدو للديبلوماسي الفرنسي مردودة. فالمسألة هي الموازنة بين الأهداف المرسومة وبين مستوى القوات. وهي تقتضي تدبراً لم يضطلع البيت الابيض بمقتضياته.
وغذى الامتناع الغربي يقين الأسد بأنه مطلق اليدين في تدمير المعارضة السورية، من غير خشية رد أميركي وأوروبي. وخسرت الفصائل السورية المحلية، وهي كانت تعوّل على مساندة غربية وربما على تدخل صريح، صدقيتها- وربحت الفصائل الجهادية، الضعيفة والمعزولة إذ ذاك، جاذبية متعاظمة، أسهم الاستيلاء الشيعي الإيراني على القصير، وتدفق الموارد المالية العربية والمتفرقة المصادر على الجهاديين، في تعظيمها. فبادرت، في كانون الأول (ديسمبر) 2013 إلى نهب مخازن سلاح الجيش السوري الحر، وهاجمت مقره المركزي في باب الهوى، حيث كان يحاول إنشاء قيادة جامعة، وانتزعت في أوائل 2014 الرقة من يده. وبدلت الحرب عند هذا المنعطف، “روحها”. وتحققت “رواية” نظام الأسد: فالمنازلة هي بين “مؤامرة إسلاموية كونية”، وبين نظام “علماني”. وسقطت الموصل في حزيران (يونيو) 2014. واستولى “داعش” على دير الزور بعد الرقة في الشهر التالي. وتُصور هذا في صورة حرب كونية بين الارهاب وبين قوى “الخير”.
المدن 27 آب/أغسطس 2019





